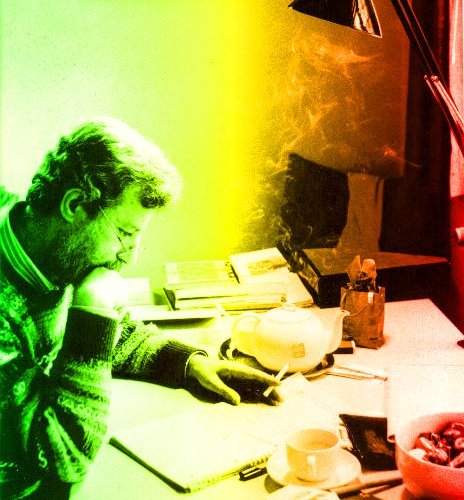الحد الأول
1.
هناك من يعترض. لن يقرأ ما سيشغل البياض. يقول : لسنا بحاجة إلى التنظير، نحن بحاجة إلى الشعر. يقول أيضاً : تقديمُ الشعر، إصدارُ بيانات، تعيينُ الحدود، خارجةٌ على عادتنا. إن سُنّة الشعر في المغرب هي الإنشاد، وتلك سنّتُهُ في عموم العالم العربي. وما عداها ليس إلا تبريراً أجنبياً عنا. يستأنس به الباحثون عن شرعية وهميّة. لك الحرية أيها المُتعرض. أما الشعر، فما زالت تواجهُه حالة ضاقت بصمتها هنا في المغرب على الأقل. توجد بيننا صناعة شعرية تتجذّر ممارستُها. إذاً، كيف ننسى، كيف نستمر في تجريبٍ خارج اللغة والجسد والتاريخ ؟ نحن في حاجة إلى البداية. إنها السلطة التي لا تقوم الكتابة بدونها. من يدّعي هذه البداية، يؤسسها، يشرّعها ؟ تلك أسئلة أخرى.
2.
لم يستطع الشعر المغربي المكتوبُ باللغة العربية الفصحى، طوال تاريخه، أن يمتلك فاعليةَ الإبداع، أي القدرةَ على تركيب نص مغاير، يخترق الجاهز المُغلق المستبدَّ، إلا في حدود مساحة مغفَلة إلى الآن، تمت في زمن مختصر، مما عرَّض غيرها، وهو الأغلب السائد، للمحْق الدائم، لتعطيل الإنتاج. وها هو الآن مُبعَد عن القراءة، منسيٌّ بين رفوف بعض المكتبات العامة والخاصة، وقد تحول إلى مادة متحفية، يستشيرها الدارسون في أحسن الأحوال، ولكن كوثائق شبه رسمية تساعد على تجلية غوامض مرحلة من المراحل، أو ملابسة من الملابسات. وهو عند الآخرين سببٌ للكسب، يقف عند رغبة ملء الصفحات البيضاء، وتدنيس براءتها، بما يدّعُونه من أبحاث ودراسات تكرّس تخلفه، كمقدمة ضرورية لتكريس سلطة سياسية لا علاقة لها بالابتكار والانعتاق.
هذا المجال الغالب من الممارسة الشعرية في المغرب نقيضُ الثقافة الشعبية أكانت لغوية، أم إيقاعية، أم بصرية.
لا داعيَ للحزن على ما ضاع منه. حتى الباقي ضائعٌ، ما دام لا يُقرأ، لا يُعيد إنتاج نفسه. لأنّ ما يبقى ويستمرُّ في التاريخ هو ما يكون فاعلاً في مصير الإنسان، وعاملاً رئيساً في تحوله وتحرّره.
غربة متجذرة تقوم بيننا وبينَ هذا الشعر. يختار القناعة والرضى ونختار الغيَّ والعصيان. يستكين للنمطية والاجترار، ونقتحم المفاجئَ والمعيشَ والمنسي. يستهدي بالذاكرة، ونصْدَع الذاكرة بالحلم والتجربة والممارسة.
هذا الشعرُ المقدس في الكتب والمقررات الرسمية ينكفئُ على موته الدائم، يخْتلي ببرودته وتكلُّسه. لا سؤالَ لديه ولا جواب،. لا حنينَ ولا كشفَ ولا مغامرة. ركامٌ من البلادة والعفن. صكوكُ الإدانة، هذه وظيفتُه. محقٌ، تكريسٌ، قهرٌ، ونفايَة.
هل نسمّيه بعد كلِّ هذا شعراً ؟
مَنْ تخاصم حوله ؟ مَنِ التجأ إليه ؟ مَنْ خلْخله ؟ مَنْ حنَّ إليه ؟
حُبسةٌ دائمة، بقايا فتَنٍ ومذابحَ واستسْلام.
3.
الشعرُ شهادّة. هذا ما استيقظ عليه الشعرُ المغربيّ الحديث، منذ العشرينيات حتى السبعينيات.
لم يكن غريباً أن تتحول وظيفةُ الشعرالمكتوب بالعربية الفصحى في المغرب، مع انبثاق العمل الوطني. كانت هذه الوظيفة في القرن التاسع عشر مجردَ نزوة، أما مع الحركة الوطنية فقد أصبحت قانوناً غير مكتوب. ولكن الوطنيين، شعراء وقراء، ارتبطوا به. وهذا ما يُسمَّى بالانبعاث في الشعر المغربي.
مع حركة التحرُّر في الريف، بقيادة الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي، بدأ تفجير بنية الشعر المغربي التقليدي، وظهور بنية مضادة في آن. التحررُ بدل الاستسلام، الجموعُ بدل المفرد، الوطنُ بدل السلطة.
كانت الشبيبة الوطنية في المقدمة. تتحلق حول نافورة القرويين، وتعيد كتابة بعض النصوص القديمة، وبعض نصوص الانبعاث في كل من مصر والشام والعراق، تؤالف بين القصيدة والنشيد، بين النشر والإنشاد، بين الإدانة والتحريض. تخلتْ هذه الشبيبة، إذاً، عن الوظيفة الإخوانية للشعر، وعن مجال المنظومات. أحسّتْ بما تنطق به قيعانُ الأنهار، مساحةُ العيون، حركاتُ الأيدي، نشرُ الأعلام، أسوارُ المعتقلات، زمنُ النفي، لحظاتُ الإعدام. كان شعرُ الشبيبة يقترب من التاريخ والممارسة، من تفسير صوت الشعب. إنها الشهادة، فسمّيناه الشعر الوطنيّ.
كانت هذه المرحلة أساساً،لأن المستقبلَ ربحَ علامةً من علامات تحوُّله. وكلُّ منْ لا ينصت لهذه النبرة المفضوحة في الشعر المغربي الحديث يُلْغَى كلامُه. فما عاشه هذا الشعرُ من ضروب القهر أكبرُ ممّا يمكن تصوّره عند القراءة الأولى.
لا مثاليةَ ولا ميتافيزيقية. لم يكنْ لهذا الشعر إلا أن يخضعَ لتطور تاريخي مُعقّد، مشروطٍ بما هو موضوعي، خارج عن ذواتِ ونياتِ الأفراد. كانت الشهادةُ انتقالاً نوعياً له أهميتُه.
ولذا بدأ ارتباطُ القارئ بهذا الشعر. مَنْ ينسَى، مِنْ بيننا، جُملةَ من القصائد والأناشيد التي ردّدناها عن حُب الحرية، والوطن، والإنسان ؟
لا علاقةَ بين النشيد والشعر، صحيح. كان هذا الشعرُ برجوازياً، صحيح. ولكن نماذجَ من هذه القصائد والأناشيد اتجهتْ إلى الأمة واختارت التحرّر، تحرر الذات والوطن. وهو مكسبٌ لا يستهان به في هذه المرحلة. فهذه الطبقة التي أنتجتْ شعرَ الوطنية هي نفسُها التي ستتراجعُ عنه فيما بعد، وستنكشف لعبتُها. ولكن فوْرة هذه المرحلة أصبحتْ مكسباً شعبياً، قبل أن تكون تملُّكاً طبقياً.
4.
واستمرت الشهادة كوظيفة أساسٍ لشعر التحرر بعد 1956. لم تعد هناكَ إمكانية للعودة إلى الوراء. تراجعَ ثلة من الشعراء، أما المبدأ فلم يقدر أحدٌ على دحْره. اتخذ طريقاً آخر. من الخارج إلى الداخل كان خَطّه. وهنا ابتدأ امتحانٌ آخر للشهادة. كان المتساقطون، النكوصيُّون، المتخاذلون، إلاّ أنّ قوة تاريخية مغايرة انطلقت. تصاعدت علاماتُ الاختيار طيلة الستينيات، وتعمقت وظيفةُ الشهادة، حتى أصبح الابتعاد عنها، مهما كان أسلوبُ الابتعاد، خيانة. هكذا تحوّل احترافُ الشهادة مدخلاً إلى ممارسة الشعر. إنّ فئات البرجوازية الصغيرة هي التي تشبثتْ بالشهادة واحتمتْ بها.
5.
لم يتكامل مبدأ الشهادةُ في الشعر المغربي الحديث مع مبدإ ثانٍ هو البحث في ماهية الشعر. من هنا كان إقصاءُ الشعر، إلغاؤُه. وها نحنُ مرة أخرى نَخضع لتقاليد الشعر المغربي القديم. وعلى هذا المستوى، لم يتغير الشعرُ في جوهره. إنها الإشكالية الكبرى. لماذا لم يتأسسْ شعرٌ عربي في المغرب ؟ ظلت الأسبقية في الشعر المغربي الحديث للشهادة، للموقفِ السياسيِّ المضاد. ومن ثم ظلت الأسبقيةُ للحديث السياسي، كحقيقة مطلقة.
كان الشعراءُ المغاربة المتقدّمون، منذ العشرينيات حتى السبعينيات، يحسُّون بأن الشهادة المضادة لشرائط القهر والتغريب لا يمكن أن تخضعَ لسلطة النصِّ الشعري التقليدي، وطنياً وعربياً.
وطنياً : كان لهم موقفٌ شعري واحد: نسيانُ هذا الموروث، سواء أكانوا من الباحثين فيه أم لا؛ عربياً: توجّهوا إلى متن آخر، استبق يقظتنا. إنه الحركات الشعرية العربية في المشرق، منذ الانبعاث حتى الشعر المعاصر، رابطين بينه وبين المتن الشعري العربي القديم، في حدود ترميم الذاكرة. متنُ هذه الحركات الحديثة أصبح مقدساً، هو المُبتدأ والمنتهَى. وكل تحوّل في الوعي الشعري – الاجتماعي في المشرق ينعكس، تبعاً لإعادة كتابة قوانين النص- الأصل، في التحول الشعري- الاجتماعي في المغرب.
خضع مفهومُ الشهادة للتطور، كما خضعَ الوعيُ الشعريُّ نفسُه للتطور. على أن الانقطاع من ناحية، وتأثر السّابق باللاحق من ناحية ثانية، وغياب مبادرة التساؤل والتأسيس من ناحية ثالثة، ألغتْ جميعُها فاعليةَ البحث في ماهية الشعر وفاعليةَ المشاركة في تثوير الشعر المغربي.
6.
مع أواسط السبعينيات، وجدَ الشعرُ المغربيُّ نفسَهُ من جديد أمام مفترق الطرق. جيلُ الخمسينيات يتجه في أغلبه نحو الصمت، وكأن القصيدة المعاصرة قد شاخت بُعَيْد ولادتها. فاجأ الشبابُ المطبعة، فاجأوا الصمت، أخذوا يُنزلون دواوينَهم إلى الأسواق، بعد أن دفعُوا ثمن طبعها من فقرهم، وحملوها على أكتافهم إلى القارئ. محمومين بالشعر كانوا. تجاربُهم تتكاثر، تتنوّع، والأصوات تتمايز.
هكذا كان قانون الشعر المغربي الحديث : في كل مرة تجنحُ إلى الصمت أصواتُ من بدأوا يمارسون الشعر، ويطلع جيل آخر شابّ، لا عهدَ له بالشعر، فلا يجد صعوبة كبيرة في تشغيلِ صفحات الجرائد الفارغة من الأصوات التي يفترض فيها الاستمرار. إذاً، لم يكن هناك صراعٌ ملموسٌ وعميقٌ حول التحولات الشعرية في المغرب، منذ العشرينيات حتى الآن، ما عدا استثناءات محصورة. مما يدلّ على أن الممارسة الشعرية ليست بعدُ، هنا، همّاً ومكابدة، ليست تقاليدُها واضحة. ينسحبُ الأولون بهدُوء، ويملأ فراغَهُم اللاحقُون بقليل من المجاهدة. اللاحقون عادة ما يطْلعُون من أنساغ الغضَب وحُبّ الانخراط في التحول وإثبات الشهادة.
هل هذا الوضع عفويٌّ أم هو نتيجة قناعة ؟ في الحالة الأخيرة، ما هي هذه القناعة ؟ هل يعتقد الجيلُ السابق بأنه مُتَجَاوَزٌ، أم أنْ لاَ جَدْوَى من الشعر في المغرب، أم أنّ الشعر لعبة مجانية يمارسُها الأطفال والمراهقون ؟
7.
من حقنا طرحُ هذه الأسئلة، فيما نُهَيّئُ للأسئلة المحرقة. لأن الانقطاعَ الذي نلاحظ تجلياته على جميع مستويات الإبداع الشعري غيرُ مساعد على خلق شرائط التحول الشعري، بل يدفعُ إلى الحيرة، خاصة وأنه يشمل الأغلبية.
لهذا الانقطاع سلبياتٌ على الممارسة الشعرية في المغرب. فالشعراء يتوقّـفون قبل البدء في كشفهم عن اللغة الشعرية، وعن طبيعة العلائق المنشبكة بين الجسد والعالم في مرحلة تاريخية دون غيرها، وعن ماهية الشعر بكل اختصار.
يصعب تفسيرُ هذه الظاهرة في ظرفيتها، إذ لا بدّ من الرجوع إلى بُعدها التاريخي، وإدْراجها ضمن البُعد الاجتماعي- الثقافي- اللغوي الذي تحكَّم في وجودها واستمرارها. وربّما كان لأسبقية الدينيّ، قديماً، والسياسيّ، حديثاً، على الشعريِّ في النص، دورٌ في سيادة هذه الظاهرة. ورغم قصور الارتكاز على ظرفية الظاهرة في التفسير، فإنّ الراهن من البحث في وضعنا الشعري القديم لا يزالُ دون الوضوح الضروري. لذا سيتمّ التركيزُ، في هذا البيان، على تأمّل الشعر المغربي في العصر الحديث، وعلى تحليل العلاقة بين الشعريّ والسياسيّ، قبل كل شيء.
يظهر، هنا، أن الشعر في المغرب الحديث ظلَّ على هامش الحديث السياسي الذي يتحكّم في كل المبادرات. فهو يجعل من الشعر تابعاً لا مُبدعاً، أسيراً لا مُتحرّراً. والكلمةُ الأولى للسياسيِّ هي لتصريف حقيقته. لهذا التهميش دورٌ سلبيٌّ في الاستمرار الشعريّ.
كانت التحوّلاتُ الشعرية في المغرب الحديث هاجسةً بالتحولات السياسية، منذ العشرينيات حتى السبعينيات، فيما تركها الحديثُ السياسيُّ تابعة، سواءٌ على مستوى الحديث النقدي أو على مستوى النشر بمختلف دلالاته، طباعة وقراءة. وعدمُ قدرة هذه التحولاتِ الشعرية على التجذر والاستمرار راجعٌ إلى البنيات السفلى للتحولات السياسية – الثقافية.
وهنا تطرح مسألة الحقيقة والسلطة. إن الحديث السياسيَّ يواجهُ الشعريَّ بما يعتبره الحقيقةَ التي هي حقيقتُه، وليس النقد والنشر إلا امتلاكاً للحقيقة. وبالتالي فإن السلطة تتجلى في إحراق مجموعة من النّصوص بدلَ الرفْع بها إلى الإنتاج. نعلمُ أنْ ليست هناك حقيقة ولكن هناك حقائق، وأنْ ليست هناك مقاربة ولكن هناك مقاربات متعددة لحقائق متعددة. يعتقد الحديثُ السياسيُّ أنه يمتلكُ الحقيقة المطلقة، وأنّ كلَّ إبداع هو مجرد تصريف لهذه الحقيقة، لأنها الأصل.
لا يمكن إنكارُ ما قدمه الحديثُ السياسيُّ من إمكانات لفرض التحولات الشعرية، والثقافية عامة، في المغرب الحديث. على أنّ معضلات النص الشعري، أكانت تاريخية أم ثقافية، قد تعرّضت للاختزال، ما دام الحديث السياسي قد حدّدَ وظيفة الشعر في الجوابِ عن السؤال السياسيِّ، لا عن السؤال الشعريِّ- التاريخي.
إن الإبداع عامة لا يمكن أنْ يتحول ويتجذر إلا من خلال أسئلته التي هي في عمقها، على مستوى ما يركّب الإبداعَ نفسَه، اجتماعيةٌ – تاريخية. ومن ثم لا يمكن تحققُ التحول والتجذر في غياب الديمقراطية. هذا جانبٌ من أزمة الإبداع الشعري في المغرب الحديث، وسببٌ رئيسٌ في الانقطاع.
وإذا كان هذا التحليلُ يصلُ إلى نتيجة واضحة، هي أن الشعر، والإبداع عامة، في المغرب، وفي العالم الثالث، شهادة قبل كل شيء، وهنا تكمُن أحقية وجوده، فإن سيادة الحديث السياسيِّ، وتهميشَه للسؤال الشعري، مُعَوِّقان لا محالة للتحولات الإبداعية التي لا فائدة في خضوعها واستسلامها. إن للإبداع قوانينَه وجدليتَه، وهي تتصل بالقوانين والجدلية الاجتماعية – التاريخية فيما تنفصل عنها. فلا يمكن أن نُساهم في التحرر الاجتماعي والتقدم التاريخي إذا نحن لم نميزْ بين المجالين، ولم نكفّ عن اعتبار أحدِ الطرفين، الإبداع والحديث السياسي، تابعاً للآخر.
إن الحديث السياسي، وهو يعتقد أنه المالكُ وحْدَه للحقيقة، يُلغي الشعرَ والإبداع، ويزجّ بهما في نقيض ما يظن أنه الآكدُ والأسبق. مما يؤدي بهذا الإسقاط، في الغالب الأعم، إلى تكريس المتخلف والمستبدّ، بدَل تعْضيدِ المتقدم والمتحرّر.
ليس هذا الجهرُ تنطُّعاً ولا تدميراً للحديث السياسي، بمشتقاته، وخاصة التقدمي منه. بل هو انصهارٌ واع ومسؤولٌ في تحويل التاريخ، ودعْوة إلى التبصُّر في الفروقات الموجودة بين قوانين القول الشعري والحديث السياسي. لا تابعَ ولا متبوع، كل منهما يعضدّ الآخر ويفتح له أفُـقه.
8.
هذا احتفالٌ برؤيةٍ مغايرة للعالم، يحاولُ أن يحتفظَ لها في الشعر بحَرارة التجربة والكشف والتجاوز.
لا مجال للادعاء هنا بأن هذا البيان تمثيلٌ لجيل السبعينيات في المغرب. فما يريدُ طرحه أبعدُ من الفصل الذي تنفضح هشاشتُه عند المراجعة الأولى لعطاء هذا الجيل ولما يوجد بينه من تنافر وتعارض. فما أعطت أسبابُ النشر لبعضه غيرَ سقَط الشعر وأرذل الكلام.
إن مفهوم الكتابة معارضٌ أساساً للشعر المعاصر، كرؤية للعالم، لها بنية السقوط والانتظار. هذا الشعر هو الذي يُواجَه هنا، كرؤية برهن التاريخ على تخاذُلها وتجاوُزها. وليس البيانُ فرضاً لرؤية ما بقدر ما هو دفْعٌ صريح للآخرين إلى الارتباط بالقلق وتبنِّي السؤال.
لقد حان الوقت للتأمّل في ما تم إنجازه، على بساطته، خاصة إذا كنا نبتعد عن السقوط في التجريب المجاني، وعن اعتبار الخلل شيئاً عابراً أو تقليداً مُلتصقاً بجلودنا كاللعْنة الدائمة.
9.
إنّها الكتابة. ليست التسميةُ بدْعَة مُنْتَحَلَة. إنها بالتأكيد شَبَحٌ، على مستوى اللاوعْي، بالنسبة لمن يجهلُونها. فهم يقومون بتصعيد خطاب سياسيٍّ لكبتها، وتكريسٍ لما يُعتقَد أنه الأصل. وإذا كانت الكتابة تعتمد أساساً على جدلية النص والممارسة التنظيرية، فإنها، من ناحية أخرى، مؤشرٌ على رؤية مغايرة، تجهد الطليعة الشعرية العربية لبلورتها. لم نجتمعْ في لجنة سرية أو علنية لوضع قوانينَها المسبقة، ولكن كلاً منا كان يحسُّ، ثم يدركُ، أنه يتجه نحو الآخر ويكمّلُه.
إن الكتابة، بهذا المعنى، ليست منعزلة في المغرب، تخْشَى الانفتاح على الآخرين. إنها مشروعٌ جماعي نتوحّد فيه. تُعيد الكتابةُ النظرَ في الجمالي، الاجتماعي، التاريخي، السياسي. ثورة مُحْتمَلة ضمن الثورة الاجتماعية المحتملة أيضاً. لا بدّ للكتابة في المغرب من مغادرة الإطار الضيق، وتسافرَ بعيداً بخصوصيتها، علاقتِها وفرْقِها.
وإذا كان هذا البيانُ يسعى إلى توضيح مفهوم الكتابة، فإن ما يطمح إليه هو تبيانُ وجهة نظر تستندُ إلى الخصوصية المغربية التي لا يمكن، في حال إلغائها، نشدانُ أيِّ ممكن من ممكنات تحول النص الشعري في المغرب.
الحد الثاني
1.
علينا أن نغيّر مسارَ الشعر. هذا ما كانت تعلنُه الدّواخل، وهي تواجهُ جملةً من النماذج القليلة التي كانت تنشرها الصحف والمجلات المغربية.
لم تكن الرؤيةُ صافيةً ولا عميقة، ولكن خلخلةً ما كانت حاضرة، لمعاناً محرقاً يخترق الأصابع، ترى إلى البياض وكأنه كلامٌ لا يشبهُ الكلام.
2.
أن نغيّرَ مسار الشعر معناه أن نُبَنْيِنَ النصّ وفْق قوانين تخرجُ على ما نسج النصَّ المعاصرَ من سقوط وانتظار، أن نؤالفَ بين التأسيس والمُواجهة.
تم الارتباط بالتأمل والممارسة، بداخل النص وخارجه، بالذات والواقع. كل هذه الثنائيات انحلّتْ على وحْدتها الجدلية الباطنية، تمازجتْ فيما بينها. كلُّ طرف يضيءُ الآخر ويشغّله، ينقله من اليقين إلى القلق، ومن الرضَى إلى السؤال. ولم يكن بين الدواخل والاحتراق حجَاب. كيف تغير؟ من أين يبدأ التغيير؟ وإلى أين يفضي ؟ أسئلة أولية وبسيطة تخنق، ترمي بالسائل والسؤال إلى مسافات بعيدة عن التآلف مع النمطية. بقي اختيارٌ وحيد : الحقيقة أو الخيانة، الاستمرارُ أو النكوص، التغييرُ أو التزييف. كان القرارُ فكانت الكتابة، كانت المغامرة.
3.
لابداية ولانهاية للمغامرة. هذه هي القاعدة الأولى لكل نصّ يؤسس ويُواجه. لابدايةَ ولانهاية الكتابة نفيٌ لكل سلطة. وبهذا المعنى لايبدأ النصُّ لينتهي، ولكنه ينتهي ليبدأ. من ثم يتجلّى النص فعلاً خلاقاً، دائمَ البحث عن سؤاله وانفتاحه، لا يخضعُ ولا يستسلمُ ولا يقمع. تَوْقٌ إلى اللانهائي اللامحدود، يعشق فوضاه وينجذب لشهوتها. كلُّ إبداع خارجٌ على زمن الإرهاب، مهما كانت صيغته وأدواته.
وهذا الفعل الخلاّق نُموٌّ محتمل للوحدة – الوحداتِ الأساسية التي تقود النص نحو التجلّي. وحين نربط النموَّ بالاحتمال فذلك راجعٌ لتعقّد الإبداع والخلق، حيث ينتفي الخطُّ المستقيم، الصاعدُ دوماً. هناك انعراجات، التواءات، تحُول دون إحداث النموّ بسرعة مطردة. غير أن الإنطلاق لا يعرف التراجُع، إن لم يكن على مستوى الفرد، فعلى مستوى الجماعة، وإن لم يكن على مستوى الحاضر، فعلى مستوى المستقبل.
ولا معنى للنموّ خارجَ التحوّل، أي نفيُ كلّ نمطية قبْلية أو نموذج مسبق. إنّ التحول الذي يمس النص، وقد نمَتْ وحدتُه – وحداتُه الأساسية، شموليٌّ لا جزئي. ومع ذلك فلنحذَرْ! هذا التحول خاضعٌ حتما لجدلية باطنية للنص، ليس من الضروري أن نكونَ واعين بكل إوالياتها، لأن الإبداع حين يخضع للوعي، للتقعيد، يعلن موته. فليست المعقوليةُ وحدها هي التي تمنح الإبداعَ شرعية وجوده. إن الإبداع، بالأحرى، مراوحةٌ بين الوعي واللاوعي، بين التذكر والتجربة والحلم، بين الإثبات والنفي. لا مجالَ هنا للانتقائية فيما لا مجالَ للتفرد والفرادة خارج التاريخ، تاريخ النص والذات والمجتمع. وبالتالي ليس التحوّل نتيجة عفوية أو مجرد رد فعل، ولكنه مشروطٌ بقوانين ندركها ولا ندْركها.
كل ما يَبدأ لينتهيَ منافٍ للتحول، منافٍ للإبداع. إنه المطمئنُّ للأصل، كلُّ شيء واضحٌ ومعلومٌ لديه. هذه نقطة الانطلاق وتلك نقطة النهاية، وبينهما شتيتُ كلام يرسّخ الوهم ويَسْتنسخُ السابق. استمرارٌ سلبيٌّ لصوت الموتى بدلَ أن يكون استقداماً لما لم يوجد بعد، للمُبهَم، المنسيِّ، الممنوع، الغريب.
النقدُ أساسُ الإبداع. هذه هي القاعدة الثانية للكتابة. حين نقولُ بالنقد نلغي القناعة، تسييدَ الكائن. وللنقد أكثر من وشيجَة بالتحوّل. النقد محاصَرة للذاكرة كمُرتكز لكلّ كلام وأصْل. آنَ لنا أن نخرّب الذاكرة كآلة متسلطة، تُفَصِّلُ الممكن على قياس الكائن، تُمنهجُ الرؤية من خلال محْو العين التي هي تاريخ كلّ نص، تستبعدُ الحُلْمَ، الممارسةَ، التجربة، تُبطل النقصان والانشقاق.
النقد هو ما لَمْ نتعلّمْه في حياتنا، نرتجفُ حين نسمعه، أو نُعَنَّفُ حين نمارسه. هيأوا كلامَنَا وجَسَدَنَا للطاعة والخضوع، بما سموه عِلْماً وما سمّوْه قيماً وأخلاقاً وما سمّوْه حياة وموتاً. لا، لم يهيّئونا فقط، بل أسْلَمُونا لعقيدة الامتثال، واشترطوها لوجُودنا. وها هُم الآن يعيدون إنتاج أجيال أخرى تَرى في الحُبسة نجاةً، وفي التهليل ارتقاءً.
أولُ ما يجب أن يتجه إليه النقد هو المُتعاليات، بمختلف تجلّياتها. ليس الغائبُ هو الذي يخلق الحاضرَ والمستقبل، بل الإنسان هو خالق حاضره ومستقبله.
لا تستصغرُوا المتعاليات. إنها المتحكّمة في وعْينا ولا وعْينا. من قبلُ أهملَها التقدميُّون حين ارتبطوا بالتقنية مؤلّهين لها، وها هُم الآن يُضيفون متعالياً محدثاً للمتعالي القديم.
إن المتعاليات، كمجال معرفي، تعتمدُ قناعة أساساً، هي أن الإنسان موجودٌ بغيره لا بنفسه، شبحٌ عابرٌ في دنياه، صورة لمثال، مصيرُهُ فوقه لا بين يديه، تُغطّيه السماءُ بحنينها مرة، وتحتفظ له الظلماتُ بالردْع، هنا أو هناك.
هذه المتعاليات، كمنظومة معرفية، تغلّف التاريخ، تنفذُ إلى مجالات معرفتنا التي توارثناها. وما ترسُّخُها في الشعر العربي عابراً، ولا في سلوكنا طارئاً. والنقد، حين يختار المتعاليات، يتوجه إلى الجذر. فهل نختلف في وضعنا عن ألمانيا القرن التاسع عشر عندما ألح أكبر فلاسفتها على نقد المتعاليات، واعتباره سابقاً على كل نقد ؟
إن أسبقية المتعاليات في النقد لا تستهين بنقد البنيات السفلى، التاريخية – الاجتماعية التي هي أساسُ استمرارِ المتعاليات ودوامها. ولكن المتعاليات يدقّ خفاؤها بين شِعاب النص والذات والمجتمع. كثيراً ما فَصَلْنا بين هذه البنيات وبين المتعاليات، واعتبرناهما متباعديْن، نُعًرِّي البنيات السفلى للمجتمع دون المتعاليات، من غير أن نفطن إلى أنّ نقدنا لهذه البنيات مُحَمَّلٌ هو الآخر ببذور متعالية يؤدي إهمالُها إلى ضمَانِ فاعليتها، وإلى عدمِ خلخلةِ النسق الرئيسي في تبنيُن المعرفة، التي يبقى الشعرُ مجالاً من مجالاتها.
إن كلَّ نقد للبنيات الاجتماعية – التاريخية كما ورثناها عن الاستعمار، في علائقها الطبقية والعرقية والإقطاعية، خارج إطار المتعالي ليس نقداً. فالنقدُ إما أن يكون شاملاً أوْ لاَ يكون.
يهدفُ النقد إلى تفكيك المفاهيم والقيم والتصورات، داخل الشعر وخارجه، انطلاقاً من التحليل العلمي للوقائع والمعطيات، والعودة بالإنسان إلى بُعده الواقعي، ماحياً كل المتعاليات التي تسلبُ منه قدرته على الفعل، وتنسب لذاتها كتابة مصير الكون على جباهنا العارية. من ثم يصبحُ النقدُ فاصلاً بين زمنين، زمن الاستسلام وزمن القرار الإنساني، وهما بداهة متعارضان في العمق.
إننا لم نَمُتْ بعد. والنقد الشاملُ صعبُ الادعاء إنْ هُو لم يتوجّه للتقنية هي الأخرى كمتعالٍ من متعالياتنا المُحدثة. وإذا كانت السلفية الشعرية قد جعلتْ من الأصالة المزعومة بُعداً أساساً من أبعادها، مهما تستّرت بلفظويتها الشعبوية والثورية تبريراً لاستمرارها الوهْمي، فإن نقد الرؤية اللاتاريخية للتقنية الأروبية، داخل الشعر وخارجه، لا يقلُّ أهمية عن نقد مُتعالياتنا القديمة. إن الاستمرارَ في النظر إلى التقنية الأوروبية السائدة هو السقوط ذاته في متعالِ يفسّخ العلائق قبل أن يوحّدها، يُغَرِّبُ الرؤية والحساسية قبل أن يساعدَ على تثويرهما.
إذاً، لا نجد في كل منَ الأصالة العمياء والتقنية المطلقة مدخلاً إلى إعادة قراءة جسْمنا بوعي جديد يستنهض المعيش والمكبوت والمنسيَّ، يفتح عيناً مغايرة لإدراك منطوق النخل والماء.
5.
لا كتابة خارج التجربة والممارسة. هذه هي القاعدة الثالثة. إن الكتابة وهي تعمد إلى نقد اللغة والذات والمجتمع، تتأسس من خلال التجربة والممارسة، قبل أي بُعْدٍ آخر من أبعاد الإبداع. والتجربة والممارسة اختراقُ الجسَد للزمن، فعلٌ أولُ لكل تجاوز.
نلحظُ بوضوح أن هذه القاعدة تشكل كلّ شعر إنساني، لدى مختلف الشعوب. من هنا تكُون الكتابة تجذيراً للمعرفة وتثويراً لها، ما دامت كلُّ المعارف الفاعلة في التاريخ ناتجة عن التجربة. ومن الخلط الحديثُ عن مادية الكتابة أو نقد المتعاليات، في غياب التجربة والممارسة كأساس لتغيير العالم.
هكذا تبتعد الكتابةُ عن قصيدة الذاكرة وقصيدة الحلم. فالسلفية، حين ترتكن إلى الذاكرة وتطمئن إليها، تقوم بإلغاء الحواس والزمن. حقيقتُها موجودة سلفاً، كل شيءٍ مرتب وتامٌّ وكامل. وهي لا تفعل غير اجترار ما تعتقد أنه النص ذاته، أنه الأصل في كل شعر ولكلّ شعر.
أما قصيدة الحلم فلا شك أنها أصبحت عنوانَ جانب هام من التجربة الشعرية المعاصرة، لا في أوروبا فقط، ولكن في العالم أجمع، نتيجة الثورة السريالية التي أعطت الأولوية للاوعي والانغلاق الذاتي للفرد. ورغم أن السريالية قد أيقظت الوعْيَ الشعري على لا وعْيه، ودعَتْ إلى تحرير المكبوت بعيداً عن كل رقابة، وخلّصَت الشعر من أوهام العقلانية ومثاليتها، فإن نتاجها من الشعر، والإبداع الآلي عامة، لم ينجُ من نقيصَة إلغاء التجربة، أكانت داخلية أم خارجية. لا يمكن أن نعوّض التجربة والممارسة بالحُلْم، بل لا يمكن أن نجعل من الحلم مدخلاً إلى الارتباط بالواقع المعيش، لغة وذاتاً ومجتمعاً. فلا معنى للحلم إنْ هو لم يكن منشبكاً بالتجربة والممارسة. لهذا تبتعد الكتابة عن الإغفاء والصدفة فيما لا تلغيهما بتاتاً.
إن الكتابة، حين تختلف عن قصيدة الذاكرة وقصيدة الحلم، تلتصق بالملموس والمحسوس، تدمر استبدادَ الذاكرة، تحاور الحلم دون أن تستسلم للانغلاق الذاتي للفرد.
6.
لا معنى للنقد والتجربة والممارسة إن هي لم تكن متجهة نحو التحرر. هذه هي القاعدة الرابعة. لا علاقة للكتابة بكلِّ نقد عدمي أو فوضوي، ولا بأيّ تجربة أو ممارسة تُعَوِّقُ تحويل الواقع وتغييره من وضعه اللاإنساني إلى احتفال جماعي. وليس النقد العلمي المناهضُ للإيديولوجيا، إلا طريقاً لتحرّر الإنسان فرداً وجماعة، داخلاً وخارجاً.
لقد أصبح الحديث عن التحرر، منذ أواسط السبعينيات، باعثاً على الريبة والنفور عند فئة كانت تدّعي العملَ من أجله في الفترة السابقة، على طول السجن العربي. ولا يمكن أن نفسّر هذا الموقف إلا بالتراجع والنكوص، بعد أن اندمجَتْ هذه الفئة، أو تسعى إلى الاندماج، في الآلة البرجوازية. ونتيجة لهذا الموقف بدأت الدعوة إلى حيادية النص وهامشيته. ولكن هذه الفئة لم تدرك (وكيف يمكنها ذلك ؟) أن الانتكاسات ليست ناتجةً عن خطإ مبدإ التحرر، ولكن عن مفهومها له وطبيعة ممارستها داخل النص وخارجه.
أخطرُ ما يظهر في مرحلة من مراحل التاريخ، وخاصة مرحلة التحول أو الإخفاق، هو تلبيسُ قيم الاستعباد أقنعة التحرر، حفرُ الخنادق المضادة للتجاوز.
لسنا مقموعين سياسياً واجتماعياً وثقافياً فقط، ولكننا مقمُوعون في مخيّلَتنا وجسَدِنا أيضاً.
ها هو مفعولُ الذّاكرة ينكشف هنا، وها هو الجاهزُ والمغلقُ والمستبدّ يتعرّى.
لا تحرّرَ خارجَ رؤية مغايرة للأشياء والإنسان، حساسية مغايرة. فمن يأخذ على المبدع الخروجَ على قالب الرؤية والحساسية يمارس قمعاً مُمَنْهجاً لتحرره ومتعته. مرت علينا فترة العَمَى. أكثر من نظام اجتماعي سلطوي ادّعى تحريرَ الإنسان اجتماعياً وثقافياً، فيما عارض تحرير الحساسية والمخيلة. وها هو الإنسان مُبْعَدٌ مُلْغًى. إن التحرر، كالنقد، إما أن يكون فعْلاً شمولياً في نموّه أوْ لا يكون.
هذا التحرر هو الذي يمسُّ الكتلة التاريخية ذات المصلحة في التغيير. تحرُّر يعيد خلق الإنسان، ككائن مبدع مُتَجاوَزٍ. كل تحرّر ينْحصر في سلطة قسرية تستعيض بالشعار عن الفعل، يُقسّم الإنسان إلى فوق وتحت، إلى داخل وخارج، يظل خادعاً مخدوعاً.
ومن تم فإن النصّ، الذي تذهب إليه الكتابة وتدعو إليه، ينبثق من خلال مواجهة مغالق النص وتفتيتها، يجذِّر فعلاً تحررياً على مستوى التجربة والمخيلة والحساسية في علاقتها بمشروع إعادة إظهار فاعلية الإنسان، والوصول به إلى حال الحضْرة الشعرية بالنص وفي النص.
إن التحرر، كفعل متنام ومتكامل أيضاً، ضرورة للكتابة، وبغيره تتحول عن أصلها. به نكون الورثاءَ الشرعيين لحركة التحرر الوطني، التي كان الشعبُ أساساً وهدفاً لها. مع ذلك فإن هناك فروقاً تميز الكتابة عن شعر الشهادة الوطنية.
وبالرغم من أن الكتابة منشغلة بالتحرّر، داخلَ النص وخارجه، فلا بدّ من توضيح ما اسْتشكَل على المبدعين والمنظّرين، أيْ طبيعة التحرر وتزامنه داخل النص وخارجه.
هناك من يعتقد أن مجردَ كتابة نص تحرري يؤدي بآلية ومباشرة إلى إحداث التحول في الواقع العيني. وهي مغالطة نتجَتْ عن عدم معرفتنا لشرائط التحول في الجالين، كل منهما على حدة؛ إضافة إلى أنها ترتبت عن استسلام المبدع للسياسيِّ، العفويِّ، الطفوليّ. إن الربط الآلي بين التحرر في النص وبالنص وبين التحرر في الواقع العيني لا يزال منتشراً، يستحوذ على عقول البسطاء الذين يزجّون بالنص والواقع معاً في شرنقة الوهْم.
إذا كان هناك تحرّر وليس هناك حريةٌ مطلقة، وكان هذا القانون منطبقاً على النص والواقع معاً، فإن تعقيدَ وخصوصية تحقق الفعل التحرري لا يدَعَان مجالاً للثورية اللفظوية. إن التحرر في النص دحرٌ للنصوص الأخرى السائدة. وهو دفْعٌ بالوعْي والفاعلية والممارسة والحساسية إلى مواقع الاستبصار والنقد، إلى إمكانية تفكيك وتركيب الموجُودات في وجُودها بصيغة تبدِّل الإدراك، وترسخ شهادةً مضادة تربك إِواليات الوعي المهادن. ليس النصُّ حيادياً، إنه يتبادل الفعل مع الواقع، على أنّ لاَ حياديتَه شيءٌ آخر. ومهما كان النص شرطاً من شرائط التحول والتحرر فإنه ليس التحولَ ولا التحررَ ذاتهما خارج النص.
7.
هي قواعد أربعة إذاً : مغامرة، نقد، تجربة وممارسة، تحرر. لنقترب قليلاً. هذه القواعد تمسُّ ثلاث مجالات، اللغة والذات والمجتمع. يصعب أن تنفصل قواعدُ الكتابة عن مجالاتها، وهي التي تريد مفاجأةَ وتركيبَ المغاير، تعملُ على الانتقال من بنية السقوط والانتظار إلى بنية التأسيس والمواجهة.
اللغــة
إن الشعر ، كما يقول هيدجر، تأسيسٌ بالكلام وفي الكلام، وهو اللغة العليا عند ملارميه، وسيّد الكلام عند ياكبسون. ليست مهمّتنا هنا هي عرضُ حدود الشعر عبر التاريخ الإنساني. ما يجب التوكيدُ عليه هو أن الشعر صناعة، إضافة إلى كونه تجربة أنطولوجية – اجتماعية. صناعة بمعنى أنه تركيبٌ لأنساق لغوية مُقْتَطَعَةٍ من الكلام اليومي وكلام الفكر. ويظلّ قانونَ الكلام المألوف، بغيةَ خلق علاقة بين الأسماء والأشياء.
كان الشعر، وهو البيت الذي يسْكُنه الإنسانُ العربي، يقومُ على الكلام، أيْ على البديهة والارتجال والوضوح. ومع التحوّل التاريخي، وظهور النزعة الفردية، انبثقت بعضُ ملامح الكتابة، على مستوى البنيتيْن النحوية والدلالية. ومع الأندلسيين والمغاربة انضافتْ بلاغة المكان إلى هاتين البنيتين، فلم يفطن لذلك المحدثون. ظل الشعرُ كلاماً، بل المعرفة ظلت كلها كلاماً. وما زلنا نردد “يؤخذ العلم من أفواه الرجال”.
سنتجنّب الدخولَ في متاهة التحليل الاجتماعي – التاريخي للغة كنسق، على عكس ما حصل، منذ أوائل الثورة الروسية حتى الآن، حيث اتجه البعضُ إلى وصف اللغة بأدوات التحليل الاجتماعي، من إقطاعية وبرجوازية، وإلى التساؤل عن طبيعة بنيتها، هل هي فوقية أم تحتية، وهل طبيعتها راجعة إلى النحو والصرف أم إلى المعجم والدلالة، لأن مثل هذه المعضلات المحيّرة لم تجد بعدُ تحليلاً علمياً تطمئن إليه.
تَجَنُّبُ المباحث اللغوية، المُصَاغَة على هذه الشاكلة، لا ينفي ارتباط اللغة العربية بالمتعاليات. فتقْعيدُ اللغة العربية خاضعٌ لنسق ماضوي يرفض مساسَها وإعادة تركيبها من خلال رؤية وحساسية مغايرتين. هذه المتعاليات أخضعت اللغة لدائرة مستبدة، زمنيتها استرسالُ الحاضر واستمراره، لا ماضي ولا مستقبل لها. ومهما تحكمت الرؤيةُ المتعاليةُ في تسييد مطلقية اللغة، فإن الشعراء المبدعين اخترقوا كوْنيتها، وهم يُوهمُون بالرضوخ لها، بعد أن نقلوها إلى مجال الغواية والمتعة، فكّكُوا مغالقها وانتهكُواعلِّيتها. على أن الكتابة الصوفية هي التجاوزُ الممكنُ لصناعة اللغة، بعد أن مزَجتْ بين الصناعة والحلم، محطمة بذلك القواعد المتعارف عليها في بنية الأنساق، وقوانين الربط الصوري بين الأشياء والأسماء. ما حصل في الكتابة الصوفية من تحولات نوعية، جعلَ منها توليفاً صدامياً للمحسُوس والمعقُول. ومع ذلك ظللنا عَازلين لها، نافين لثوريتها، متوهّمين منْسيَّها معلوماً. هناك من أعطاها هيئة النثر، وهناك من ألغاها.
إن اللغة التي لا تَحترفُ الانشقاق والنقصان، أي الخروجَ على النمطية الوهمية، اعتماداً على أرقى المعارف العلمية، عاجزةٌ عن أن تستوعب الذات المترنِّحة واللحظة التاريخية اللتيْن تريد أن تحيى بهما ولهما.
وما فصْلُنا إلى الآن بين الشعر وقصيدة النثر إلا استمراراً للمتعاليات التي ندّعي أننا نتجاوزها. فقصيدة النثر، عند الوعْي السائد، هي نقيض القصيدة الموزونة أو ما سمي بالعمودية، دون أن ندرك بأن الإيقاع الخارجي ما كان، حتى في العصر الجاهلي، أساسَ الشعر. بل إن الدلالة الشعرية هي الهَمْ الرئيس لكل شاعر، وما الوزن والإيقاع إلا قالباً تتفاعل معه الدلالة دون أن تُفرَغ فيه.
واللغة أعقدُ من التصور المتداول، فهي ما يركب النص زماناً، ومكاناً، ونحواً، وبلاغة.
(أ) يخالف المكان الشعري كلاً من أزمنة التاريخ والنحو والتقنية. زمان الشعر متشكل من منظومة الدواخ. إنه النَّفَس، بكل توتراته وانبساطاته، لا يستسلم حتماً لتقعيد مسبق، يتبع نسق الذات والمجتمع من ناحية، ولعبة الكتابة من ناحية ثانية. إنه إيقاع الوعي واللاوعي في تجلياته التي لا ضابط لها عند القراءة الأولى، غير أن خصوصيته تتضح عند دمج الرؤية بإيقاع التاريخ، ببقايا أصوات بعيدة تنبعث من أشيائنا القريبة التي لا تراها العين المغلقة.
ليس التشكّل الإيقاعي على هيئة قالب إلا احتمالاً من بين الاحتمالات. ومن هنا تختار الكتابةُ حريةَ الانتقال من الوحدات التي اعتبرت أساساً في الشعر العربي إلى وحدات أخرى ليس من الضروري أن نكون واعين بها دوماً. فالربط بين الوحدات الصوتية والوحدات النحوية والوحدات الدلالية، تبعاً لإيقاع النفس، هو ما يؤسس إيقاعاً مغايراً له صيحةُ المغامرة وحجةُ التجربة والممارسة وألقُ الخروج. قوانين اللاوعي التي نجهل أسرارها تتدخّل حتماً في صوغ هذا الإيقاع، على أنها في عُنْفُوَانِهَا مرة، وانسيابها مرة أخرى، تُكوْكبُ الكَلام أو تَشْبِكه، تثقبه أو تبتُره، تؤالف بين انغلاقه وانفتاحه، تهيئه نسيجاً وما هو بالنسيج. هذا هو الزمان الذي تجتلبه الكتابة أوْ يستقدمها، أزمنة لا زمان واحد.
لقد كان الكلام الشعري العربي خاضعاً لميتافيزيقية البداية والنهاية، بعد أن قَعَّدَهما قالبٌ تتوحد فيه الوقفاتُ الإيقاعية والنحوية والدلالية. من ثم توافَق الزمان الأوْحدُ مع النفَس الأوْحَد داخل القصيدة، مما جعل الشعر غناءً ينبني إيقاعُه على النمطية والتكرار.
إن الزمان في الكتابة مضادٌّ لحتمية البداية والنهاية، تقدُّمٌ له حرية تكسير توحد الوقفات، يدفع بالوحدات الإيقاعية نحو متاه مغامرتها آناً، ويلعب بها التقطُّعُ أو المحو آناً آخر. وليس هذا الشتيتُ منَ الأزمنة إلا تدميراً لاستبدادية القالب، وممارسةَ شرعية ملغاة في إعادة تبنْيُن النص وفق اتجاهات النَّفَس وتماديه في خرق الجاهز، وبالتالي تهْجير الجسد من خطه الميتافيزيقي المستقيم المعلوم نحو أفق آخر يمنح لكل من الحياة والموت دلالة مغايرة.
زمان الكتابة، إذاً، تجربة وممارسة، يُعيد فيه الجسدُ تكوينَه باختياره، وهو المسؤول عن هذا الاختيار، لا القالب – الذاكرة الذي يُطوّع الجسَد للحبسة والتخلي عن نشوة المغامرة وجلال الخلق.
(ب) أما بنية المكان فهي التي تجاهلها أو جهلَها نقادُ الشعر المعاصر، في عموم العالم العربي، وقد أسرَهُمْ الإيقاع. وما ذلك إلا نتيجة انحيازهم للكلام، وإلغائهم الكتابة. وهم في موقفهم هذا على عكس بعض الشعراء والنقاد الأندلسيين والمغاربة القدماء، وبعض الشعراء الأوروبيين والأمريكيين اللاتينيين المعاصرين، وكذلك بعض الشعراء الآسيويين، يابانيين وصينيين، الذين جعلوا من التركيب الخطي بُعْداً بلاغياُ يفتح النصَّ على البصر بعد أن اكتفى بالسمع زمناً طويلاً.
يبتعد المكان في الكتابة عن مفهومه كحيّز في الفضاءات المتعددة الموجودة خارج الورقة. إنه منحصرٌ في علاقة الخط بالصفحة البيضاء. فاللغة، من حيث هي منطوقٌ زمان، ومن حيث هي خطٌّ مكان. وما كان للعرب اهتمامٌ فائق بالزمان إلا لكون الشعر كان عندهم كلاماً، أما المكان فلم ينتبه الشعراء إلى تركيب قوانينه إلا مع ظهور مجتمع الكتابة.
وإذا كان شعراؤنا القدماء قد حَصَرُوا بنية المكان في قوالب اتخذتْ أرقى أشكالها من التختيم والتفصيل والتشجير، حيث أدخلها الأندلسيون في مساحات بديعة تعتمد توشيح المكان، بعد أن كان التناظر الصارمُ هو القالب الأساس لتخطيط القصائد، تبعاً لقالب الإيقاع، فإن قوانين ملء/ إفراغ المكان بالنسبة للكتابة متعددة ولا نهائية، ما دامت تخرج على النمطية، حتى يفاجئ كلَّ نص عيْنَه كما تُفاجئ العينُ تاريخَها وتكْتبه.
إن الكتابة دعوة إلى ضرورة إعادة تركيب المكان، وإخضاعه لبنْيَنة مغايرةٍ. وهذا لايتمّ بالخط وحده، إذ يصحب الخطَّ الفراغُ، وهو ما لم ينتبه له بعض من يخطّون نصوصهم بدل اعتماد حروف المطبعة. علاقة الخط بالفراغ لعبة. إنها لعبة الأبيض والأسود، بل لعبة الألوان. وكما أنّ لكل لعبة قواعدَها، فإن الصدفة تنتفي. ومن ثم تؤكد الكتابة على صناعيتها وماديتها. وعدمُ الاحتفال بالفراغ سقوطٌ في الكتابة المملوءة التي لا تترك مجالاً لممارسة حدود الرغبة، إذ أن كل كتابة مسطرة لحدٍّ واحد يدعي تملُّك الحقيقة، يوجدُ ضمن خط الحياة الميتافيزيقي، ببدايته ونهايته المعلومتين.
على أن هذه الكتابة، ببياضها وسوادها، تقاومُ مسْلكَ التشخيص الذي تركّبه الأشكال الخطية في بعض التجارب الأوروبية، كما تتخلى عن كل تشخيص أو نقل لأشكال خارج الخط الكتابي، وهذا فرق من فروقها الذي تطمئن إليه. تركيب المكان، من خلال الخط الكتابي، ليس انسياقاً وراء شَركِ الحكائية أو إقحاماً لما هو غير خطي في فضاء النص. هذه إشارة ضرورية إلى الفرق بين الكتابة وخطياتُ أبولينير وتجارب السرياليين.
ليس الخط حِلْيَة تنضاف إلى الكلام، إلى الصوت، إلى الزمان. من يقول بمثل هذا الحكم يظلُّ مستسلماً لتيْهه، لأنه لا يخرج عن الدائرة الميتافيزيقية التي تعطي الأولوية للصوت، وتجعل الخط مجرد حامل للمعاني. عندما نخضع الخط للوعي النقدي نتبين أنه بعيدٌ عن أن يكون قناعاً، بل هونسق مغاير يخترق اللغة، يعيدُ تكوينها وتأسيسها. من ثم يتضح لنا كيف أن البحث يستلزم اختراقَ الكلام، الصوت، بالخط الذي يملك سرَّه الخاص لقلب المفهوم السائد للشعر، وهو فعلٌ يجذر مادية الكتابة وجدليتها.
تُولد الكتابة في لحظة فراغ، وهنا تمارس الذاتُ تكوينَها. ومَنْ يُنكر على الكتابة إعادة بنينة المكان، يمنع كتابة جسد ينتشي بموسقية الخط، موسيقية تمنح النص سلالمَ من الأنغام والألحان. واختزال الكتابة إلى مجرد فضاء بصري تلصق به تسمية القصيدة البصرية يَتَخَفَّى وراء الظاهر، ما دامت الكتابة لا تقوم على البياض والسواد وحدهما، وإنما هي كوكبٌ لغويٌّ متعددُ الفضاءات، كلُّ قوانينه مشكّلة لوحدته.
وها هي الكتابة، إذاً، لا تخرج على المألوف لأجل التعلق بأوهام أخرى، ولكنها بحْث عن بلاغة مغايرة يتطلب استحداث قوانين مغايرة للنص. على أنها لا تنساق وراء الغيِّ والعصيان. إن مفهوم الخط، كما تمّ توضيحه، يمكّن من الخروج على دائرة الكلام المغلقة، يرحل بالجسد بعيداً، حيث الاحتفال بالمنسيِّ يحتفظ بتحرر أعمق لم نكن نسائله.
يظهر أن الخط المطبعي عادة ما يلغي النصَّ كجسد. حروفٌ باردة تسقط على الأوراق- البياض، يتحكم فيها سَفَرٌ من اليمين إلى اليسار يختزل النص في معنى، والمعنى في كلام، يمحو نشوة القراءة وتعدد الدلالة. اتجاهٌ واحد أوْحَد يخضع لأمر المتعالي، ويستكين لنمطية الحرف وتكراريته واستهلاكيته، فيما لا ينجو من تشويش الأخطاء أو تهميش التصفيف والإخراج. شيء ما يظلُّ غائباً. إنه الجسد المترنّح في ظل الحضرة.
من هنا يتدخل الخط لردع المتعاليات، من أصولية وانغلاق دائري واستهلاك. تتحرر يدُك، عينُك، أعضاؤُك. كلُّ الاتجاهات تصبح ممكنة، تحطم استبداديةَ اليمين، أصوليةَ الشرق ومآليةَ الغرب. ينفتح الخط على تاريخه، يدمر ميتافيزيقيته وهو يتبع حركة الجسد ونشوته. نحرّر حواسّك، أليافَك. كلّ الدلالات تصبح ممكنة. تحطم استبدادية المعنى، الكلام، الصوت الخفي. ينقل الخطُّ النصَّ من المعنى إلى ما بعد المعنى.
تدخل الكتابةُ حضْرتَها. أجسادٌ بمجموعها تلتقي، تعيد رؤية الأشياء والإنسان، تُغَيّرُ الحساسية. جسدُ الكاتب، جسدُ النص، جسدُ القارئ. إلغاء لأحادية الكلام، استقدام لجدلية الكتابة وإقرارها. كل جسدٍ يكتبُ الآخر، يجدّده، يحرّره. لا الكتابة مبشّر بحقيقة مطلقة، ولا النص حاملٌ محايد للمعنى، ولا القارئ مقموع مُبعَد عن إعادة إنتاج المعنى. هذه الكتابة، من حيث هي صناعة، تركيب لكون آخر محتمل، تتمُّ به وفيه إعادة تكوين الأشياء والأسماء والإنسان وفق قانون مغاير، له الوعي النقدي، له المحو، الحلم، الاشتهاء. لا بداية له ولا نهاية. نفيٌ لكل سلطة، تناولٌ للوجود والموجودات من أفق يحُثّ على التحرر المتكامل.
ويعود الخط المغربي. كثيراً ما كبتْنا عشقنا للخط المغربي، هذا الأثر الآخر الذي يمنح هويتنا ابتهاجاً. وإعلانُ عشقنا له، اليوم، علامة على عودة المكبوت. حاولنا محْقَ هذا العشقَ، تنويمَه، بحُجة تكريس وحدة الخط العربي، وحدة الذوق، وحدة الحساسية. كنّا سدّجاً، لأن الكبت المتزايد لم يحمل معه غير التصدع المتصاعد لحُجَجنا. كان المشرق بالنسبة لنا مصدرَ الحقيقة، الصوابِ والخطأ. ومع صدور “الاسم العربي الجريح” و “ديوان الخط العربي” لعبد الكريم الخطيبي انفجرت العين وتاهت اليد. كان الجسد يستيقظ على ذهوله. آثارنا التي نوّمْناها باسم الوحدة تبغتُنا وتأخذنا مواربة. ولم ندرك أن الوحدة الحقيقيةَ هي التي تنبثقُ من فروقنا المتعددة، حيث ينتفي استبدادُ المركز، واستبعادُ مختلف الإمكانات. وحدة المجموع لا وحدة المفرد هي التي نسير إليها، يكفي ما آلت إليه وحدةُ المفرد من انغلاق وانهيَار وإرْهاب.
لم نكن وحْدنا مكبوتين، بل الخط المغربي هو الآخر انزاح عن فضاء العين، دخل مدرّجات الأقبية وانزوى. ألغاهُ الخطّ المشرقيّ لأول مرة في العصر الحديث، مع الدعوة إلى الخروج من التخلف. تلك قصة أخرى. لم تكن خرافة الحداثة غير استسلام لنمطية تقمع أُحاديةُ المفرد بها تعدديةَ المجموع.
حان الوقت لنمنحَ النصَّ ابتهاجَه، ونستردّ ملْكيتنا للخط المغربي. بعضهم يقول إن الخط المغربي متمنعُ الاستعمال في كتابة تحررية، ما دامت تاريخيته مُحْكَمة الوصل بالسلطة والمتعاليات. لا تنسَوْا أن الوعْيَ النقدي منهج أساس في الكتابة. تأمَّلُوا قليلاً، ها هو الخط المغربي يمتد من الأندلس غرباً وشمالاً إلى حدود مصر شرقاً، وبعض البلاد الإفريقية جنوباً. مغربيٌّ بهذا المعنى لا يقتصر على المغرب السياسي، ولكنه المغرب الجغرافي الذي أنتج وأبدع خصوصية هذا الخط. متنوعٌ في تقنياته حتى لكأنه مسافات من الموسيقى والغناء. عطاء شعبي قبل أن يكون إمضاء سلطوياً. نرُجُّ فيه الثوابت ونخلخل الاطمئنان. إنه مِلْكيتُنا نحن أيضاً، نعلن خروجنا عليه فيما نحن داخله، بين الخارج والداخل نُقيم. نسترد هذا الخط ونسائله، نفكك أسطوريته ومتعاليات، لا تغوينا جماليته بقدر ما ننصت فيه لأثر من آثار جسدنا. لا مجال للحجَاج إذاً. لقد عرف الخط العربي، ومنه المغربي، كيف يدمّر المعنى المستبدّ، ويبني لنفسه نسقاً مُتمنِّعاً على الخضوع لسلطة المتعاليات. وها هي الكتابة تمارس لعبة النرد بعيداً عن كل صدفة.
عودة الخط المغربي تتنصّل من كل قطيعة معَ الأنواع الأخرى من الخطوط العربية، أو مع الممارسات الخطية خارج العالم العربي. لأن الكتابة تنبذ الانغلاق مهما كانت صيغته، فيما هي لا تستسلم لمحو الفرق. إنها مغربية، عربية، إنسانية.
(ج) يَنتجُ التركيبُ النحوي للنص عن طبيعة البنيات النظمية والصرفية، التي تتحكم أيضاً في تحديد المتتالية – المتتاليات وتوزيعها. إن النص بعيدٌ عن أن يكون ركاماً من الأدلة المتجاوزة فيما بينها، بل هو نسج مُعَقَّدٌ لأدلة متفاعلة ضمن علائق ترابطية وتواردية. وإذا كان الكلامُ المألوف، الكلامُ اليومي وكلامُ الفكر، تابعاً للقوانين العامة التي تُبنْيِنُ لغةَ التواصل بين الناس، أو لغة قهر الناس لبعضهم البعض، سواء على مستوى المداليل والدلائل، فإن الشعرَ يخترق هذه القوانين ويخرج عليها، مؤسساً لقوانين خاصة لم يَتَمَلَّك العلم الحديث جلَّ أسرارها.
والخروجُ من القوانين العامة إلى القوانين الخاصة لا يأتي صدفة، ولكنه بحث في سؤال الإبداع. من ثم فإن طبيعة الترابط والتوارد داخل النص شكّلَ لعبةً للخروج على القوانين اللغوية العامة، وهو نواة لتركيب النص وتعيين رؤيته للعالم.
كان الإيقاع ولا يزال مخلخلاً للبنية النحوية. فكل صراع بين قوانين الإيقاع وقوانين النحو تكون نتيجته انتصارَ الإيقاع على النحو. وما الإيقاع إلا النفَس. لذا فإن ما يحدّد المتتاليات داخل النص هو هذا النفَس، ضوءُ الجسد النافذ إلى عتمة الكلام اليومي وقوانينه العامة. إنه أيضاَ رؤية المبدع للعالم. تدمير القوانين العامة، وإعادة تركيب المتتالية – المتتاليات، حسب إيقاع النفَس، مقدمةٌ لتدمير سلطة اللغة وأنماط الخضوع لتراتب مسبق للوجود والموجودات.
عادة ما يتميز النص الشعري المعاصر في المغرب بتراتُب مانويٍّ، من حيث الزمان النحوي، لجملتي الخبر والإنشاء، النفي والإثبات. غالباً ما يصالح السياق، ويعطي لكل من الجملتين فضاءها الخاص بها.
إن التفاعل الجدلي بين النص من ناحية، واللغة والذات والمجتمع من ناحية ثانية، يعطي للقراءة خصيصتها. فالكتابة، كقراءة تسعى إلى تدمير التراتب المانوي، وتصدُّعِ الترابط والتوارد الصوريّيْن، لتشبكَ الخبر بالإنشاء، النفي بالإثبات، تعيدُ صوغ توزيع الأزمنة، تدفعُ بالضمائر لمحو حدودها، تعودُ باللغة إلى ما قبل الترقيم، ترتاحُ لانتفاء أدوات العطف، تعضدُ الحذف وترسخُه، مزلاجاً مرة يأتي، ومرة فواتح، مما يعرض الخبر والإنشاء، النفي والإثبات، المتكلم والمخاطب والغائب، الماضي والحاضر والمستقبل، للإلغاء. في الأولى تشير إلى التفاعل بين الأطراف المتناقضة والمتعارضة، وفي الثانية تتركُ الفعل مُعَلَّقاً.
هذا الفعل التدميري يهيئُ للقارئ حضْرتَه. فهو الذي يعيد تركيب المتتالية – المتتاليات بنَفَسه، يعيد تكوين النص فيما النصُّ يعيدُ تكوينَ جسدِه، رؤيتَه للعالم. من هنا تكون القراءة إبداعاً وتأسيساً لعالم ولحساسية مغايريْن، لهما اشتهاءُ المواجهة.
عُرف الشعر بلا نحويته، أوْ أن نحْوَه ليس هو النحوُ العام. غير أن درجة لا نحوية الشعر غيرُ مؤتلفة بين أنماط الوعي الشعري، ولا جذريتُها متساوية. وحين تتجِه الكتابة إلى تعميق تدمير النحوية داخل النص، وتلحمها برؤية مغايرة للعالم، فإنها تختار شرائط مغايرة لعلائق مغايرة، داخل النص وخارجه. من هنا ندرك كيف أن الشعر يصبح سيّدَ الكلام. فهو المُعيد لخلق فاعلية اللغة، لتبدّلات الرؤى والحساسيات، وهو المواجِهُ لتسْييد خضوعٍ داخلَ وخارجَ الفرد والجماعة.
إن فورانَ الجسد وتعميقَ الوعي النقدي هما المؤديان إلى مساءلة القوانين العامة للغة، وتفتيت متعالياتها، وإعطائها خصيصتها التاريخية، من خلال استحداث قوانين مضادة، تمحو العليّة، ونُفصِحُ عن مادية الكتابة وجدليتها.
(د) تعلمنا منذ مقتبل العمر كيف نرى إلى النص كلُعبة أسلوبية. لا يتركّب النص إلا من أدلة، أدلة فقط، ومع ذلك فإن كل أصولية أسلوبية تظل فعلاً بَرَّانياً. إن الكتابة بحث عن أسلوب، ولكنها ليست حنيناً أسلوبياً. حروف تنتقي حروفاً، أدلة تعضّد أدلة، والبلاغة صناعة أيضاً. تغييرُ الأدلة من مواقعها داخل الأنساق اللغوية، وتفجيرُ مدلولاتها المنسية أو المكبوتة، بعيدان عن الصدفة. فهما مغامرة تشتهي استنطاق رؤيةٍ وتدمير سيادة.
استنطاقُ رؤية، بمعنى أن النص يتحول إلى مجال إشاري، يختطف الحال ويمحو المعنى الواحد، يغوي الاستعارة والمجاز وينسى التنميق، يفسّخ العلائق الوهمية بين الأشياء والأسماء، يُخفي ويُضمر قبل أن يبوح ويصرّح. وما هذا الاستنطاق إلا تدميراً لسيادة المعنى الواحد وأسبقيته داخل النص. لا المعنى الواحدُ هو الحاضر بل المعَاني. لا الحقيقة هي المستبدة بل الحقائق. من ثم تأخذ المغامرةُ، النقدُ، التجربةُ والممارسةُ، التحررُ، دلالاتها داخل النص.
يُفْسِح الجسدُ للعين في مجال الرؤية، وتكتب العينُ تاريخَ الجسد، كل منهما يتبادل مع الآخر لعبة إعادة إدراك الوجود والموجودات. وتمارسُ الكتابة افتضاضَ المألوف، السائد، المغْلق، المعتاد. هذا الافتضاضَ الذي جرّب قساوته ونشوته كبارُ المبدعين. إن الكتابة قلبُ المداليل والدلائل، لذلك نتساءل : أليست الكتابة حرثاً ؟
تتمازج بنياتُ الزمان والمكان والنحو في رتْق بلاغة الكتابة. كل منها مؤثر في اللآخر ومُفْض إلى تركيب كلية النص وتحولاته. لا تأتي هذه البنيات أفواجاً أفواجاً، ولكنها تولد، جميعاَ، في لحظة بياض، حيث تحيا الذات حالَ إعادة التكوين، وتصبح اللغة برمتها إشكالية. لا التواصلُ مع القارئ هو المطروح ولكن سؤال البدء. لا هبَةً عَليَّة ولا إلهاماً. تولد الكتابةُ مُجاهَدَة واستمتاعاً. سردٌ، غناء، حوار، وصف. لا سردَ، لا غناءَ، لا حوارَ، لا وصفَ. وما هي الكتابة إذن ؟ هي ما يبحثُ باستمرار عن سؤاله لا عن يقينه باللغة وفي اللغة. وتستعصي الكتابة على الذاكرة، تُصَدِّعُها، تَقْلب سياقَ المعَارف، تلْعبُ بها، حادثة، إسماً، أغنية، مثلاً، رواية، علامة. لعبة يقعِّدها الوعيُ واللاوعي، التقريرُ والتخييل، الواقعُ والرمز. والنسيان مبدأ بلاغة الكتابة.
إن مغامرة بلاغة الكتابة تكفّ عن إظهارالمبدع وكأن نفحة علوية حلّتْ فيه، أو كأنّ مساً شيطانياً خالطه، أو أن هذا المبدع حذقَ تحريك الكراكيز. هذه المفاهيم والتصورات ساقطة، لأن مغامرة بلاغة الكتابة رحيلٌ بين الجسد وبياض الورقة، يحدث في زمن- أزمنة السؤال.
كل نص يبحث عن أسلوبه، في مرحلة من المراحل التاريخية، هو نتيجة تبدّلات في علائق الإنسان بالموجودات، تبدّلات في خصيصة الأبعاد التي تُبنْـيِن النص وتقعّد بلاغته. إنه الخروج على الاستسلام. هذا ضربٌ من الغموض. ومنْ ثمّ يُصبح كلُّ جديد معزولاً، لا لأن العلائق اللغوية تعرضت للقلب، بل لأن الشرائط الاجتماعية والتاريخية والثقافية السائدة هي الأخرى تُحاصِرُ التحرر، تمنعُ التساؤل، وتردعُ كل رؤية تخرج على القمع وتختار مصيرها،بقوانينها المتميزة، ضمن الكتلة التاريخية ذات المصلحة في التغيير. النص الواضحُ، الأحاديُّ المعنى، هو النص السائد، النص الذي يكرّس الاستهلاك والإخضاع.
وتبدّلُ القوانين البلاغية من متن إلى متن، ومن نص إلى نص، ومن فئة إلى فئة، ومن عصر إلى عصر، ضرورة لكل تحول وتحرر. لا علاقة للكتابة بالتبدّلات العفوية الساذجة التي تصالح الكائن والمستبد. مشروعُ بلاغة الكتابة منشبكٌ بشرط التحرر الإنساني من كل المتعاليات، قديمها وحديثها.
وإذا كانت الكتابة تمارس لعبة إغْماض النص، لأنها ترى إلى الأشياء بعيْن ثالثة، فإن التغميضَ والتعميمَ غريبان عنها. مع ذلك تتشبثُ الكتابة بلا أخلاقية بلاغتها. فهي معزولة عن حدود الحسَن والقبيح، الجيّد والرديء. بلاغة تتحاشَى اجترارَ أوْ تصريفَ قيم الذوق والجمال، القائمةِ على الوضوح كمبدإ أساس لكل بلاغة.
الـذات
في الذات لا في القواميس تتجمهر اللغة، تتعلم كيف تنهض، تعاود التكوين والتأسيس. لا تغيير يفاجئ اللغة دونما تغيّر في الوعي والحساسية. للذات سلطة الانتهاك والاختراق، من خلل منسيِّها وجُرحها وشُرودها وشهْوتها وصِرَاعها. إنها الجسَد. وهي غير محايدة في إعادة بنْيَـنة النص.
كثيراً ما نَوَّمْنَا الذات، في آنيتها واستمراريتها، باسْم الشهادة. حذفنا آثارها ونُدوبَها، وكأنها عضوٌ زائد لا بدّ من استئصاله. اعتبرناها دخيلة، تشوّش على النصّ في اختيار مواقفه ودعوته لرفض الكائن المستبد.
ما أكبرغَباوتنا عندما استسلمنا لأقاويل الوهْم، وخَضعْنا، رغماً عنَّا، لسلطة السياسي الذي لا يرى في الإبداع إلا تابعاً لحقيقته! كان هذا القالبُ امتداداً للنظرة الستالينية التي انتقلتْ مع ما سُمّي بالواقعية الاشتراكية إلى العالم العربي، فيما هي استمرارٌ لتاريخ هيمنة الديني على الشعري. وما عاد هناك، اليوم، مبررٌ للخضوع.
هذه الذاتُ ليست عاقلة وواعية دوماً. إنها اللاوعي المندمغُ في الوعي، الجنونُ الذي يُسَالمه العقل، والفوضى التي يُنَمَّطها الانضباط. فورانٌ مستميتٌ لعوالم لامتناهية، يصارع كُمُونَهَا الانبثاقُ، ولغزَها الوضوحُ. غالبها الكبتُ باسْم المتعاليات والقيم والأخلاق، فَلَمْ ترتَحْ لتوتّـراتها الغامضة. شبكة من المُبْهم الذي لا قاهرَ له، يختفي ويتفجرُ لحظات. وما الكتابة إلا مجالَ استعادة الذات لحريتها، تسائل الطفولة، تستبيح المتعة، تصالح الحلم، تُسَلِّحُ الاحتجاجَ والرفضَ والاجْتياح.
من قبلُ جاء الرومانسيون بمبدإ الذات في الإبداع، فكان لها النسفُ والفجع، تُمجِّدُ كبرياءها وتنهار مع أيِّ وشوشة تطالها. ومع كل قصورها الذي ظهرت عليه في العالم العربي، تبعاً لتخلف البنيات الطبقية ورخاوة الصراع، فإنها تحولَتْ إلى ثورة حقّق لها جبران جلالَها. احتقرنا الرومانسية قبل أن نعيدها إلى تاريخيتها، واعتبرناها نكوصاً وارتداداً. ما أبشعَ جهْلَنا! إن ثورة الذات الرومانسية أنتجت إحدى أهم الثورات الأدبية في تاريخ الإنسانية. ثورة فردانية حقاً، قاصرة عنْ إدراك إواليات العالم المعاصر، غير أنها في آن أقوى مدمّر لسلطة الإقطاع العاتية. هذا ما ننساه ونتجاهله.
ليست الكتابة عوْدةً متخفّيةً لآهات الرومانسية. فلا حاجة لتعداد مناحي تخلف الوعي الرومانسي، ومع ذلك لا قطيعة نهائية للكتابة مع الرومانسية التي احتفلت بالذات.
إن الكتابة، وهي تستعيد الاحتفالَ الرومانسي بالذات، تعلن عن فرْقها. الذات، في الكتابة، تاريخية لا ميتافيزيقية، مستوياتها الواقع والرمز والتخييل، لا الإشراقُ والإلهامُ والارتجال. تاريخية بمعنى أنها نسْبيةٌ، لا مطلقة.
لا نستطيع بعد الآن أن ندّعي العمل من أجل التحرر الإنساني فيما نترك الذاتَ ملغاةً، سجينةَ المتعاليات، من هُوية وأصْل. جروحُها اللانهائية مستعْصيةٌ على المحو بمجرد أمر. إنها الدواخل التي تحترق دونما بَخُور، نقيضُ الذات الخارجية السطحية المتماسكة التي لا ماضي ولا حاضر ولا مستقبل لها، لا حياة ولا موت، تَكَلُّسٌ يهتدي بالقرار. وفي انتقاله من حال إلى حال يغادر جنونه وفورانه اللانهائيين. هذه الذات الملغاة، المشلولة، هي التي تحتاج إلى النقد. نحو استسلامها وبرودتها تتوجّه الكتابة، تكشف عن سقَمها وهَشاشَتها. فالذات المقيّدة بجُمَل الأمر وقَوالب الكلام الجَاهز وصيَغ الردْع هي التي تريد الكتابةُ أن تفكّكها وتسائلها، تعرّضها للشمس وقد طال مكوثها في القبْو.
ذاتُ الكتابة تسْعى إلى المعرفة لأنها منخرطة في التجربة والممارسة. وهي بذلك ذاتٌ مادية، غير محايدة، فاعلة في تحديد جهَة التاريخ. ولأنها أرضيّة لا عُلْوِية فهي اجتماعية، تحترف الانشقاق والنقصان.
لا يمكن أن نحرّر الفعلَ في ظل قمع الذات، لا يمكن أن نفتتح حواراً مع المستقبل ونحن رهائنُ للماضي والحاضر، لا يمكن لفاعلية الإبداع أن تتفجر ونحن مطمئنون لحيادية الذات. وها هي الكتابة تهيئُ للجسد حضْرتَه. لا تتوجّه الكتابةُ لحضارة القمع، بل لحضارة الجسَد، مندفعة في حالها وتجلياتها. تختار النَّفَسَ وحْشياً، موحَّداً ومتصارعاً، في آن، مع لحظات الغناء الشاردة. كلٌّ يأخذ الآخر نحو تحرّره، نشْوته، والكلُّ للكل يصُوغ حضورَ الذات العلنيّ. فالذات هي المُبْعَدُ الذي يستردّ خَصيصَته، ويتُوه بعيداً، بعيداً عن الطارئ والعابر.
ذاتٌ لا نهايةَ ولا بدايةَ لها. خطُّ حياتها متعرِّجٌ متقطّع، لا مستقيمَ له ولا معلوم. ذاتٌ تتكوَّنُ بالكتابة وفي الكتابة، فيما تُكَوّنُ الكتابة نَفَساً يولد في لحظة بياض. إيقاعُ حضارة التحرر.
المجتمع
تهدف الكتابةُ إلى بلورة رؤية مغايرة للعالم، تستمد من التأسيس والمواجهة بنيتها الرئيسة. والمجتمع فاعلٌ في وجود العالم وصيرورته. على أن المجتمع العربي، ومنه المغربي، لَمْ يَخْتَرْ ولا يختارُ حياته بمحض إرادته، بعكس ما تحاول أن تُوهمنا بذلك أيديولوجية الهيمنة والاستبداد، من خلال مقيداتها ومروياتها. إن المجتمع العربي مغلولٌ في ماضيه وحاضره بالأمر والردع والاستعباد، مبعَدٌ عن الابتكار والتحرر. وبرغم تحكم الصوت والسيف في مسافة خطواته واتجاهها، فقد استيقظَ على تدمير الإِخْضَاع هنا وهناك، بصيَغٍ وأنماط متعددة.
ليس هذا تلخيصاً لتاريخ عالم لَا يزال ينطق من بين أدلَّتنا، ولكنه استخلاصٌ يُموضعنا داخل العلاقة بين الكتابة والمجتمع.
كان الشعر العربي الحديث، ومنه المغربي، أكثر تقدماً حين رَسَّخَ مبدأ الشهادة، ونقلها من الخارج إلى الداخل، من الماضي إلى الحاضر، من المركز الاحتكاري إلى الهيمنة الوطنية. كلُّ هذا ليس كافياً.
إن الأدب، في تاريخه، وأشكاله، ورؤاه، ليسَ متجانساً. فهو متعارض ومتناقض، يعكس من خلال بنيته الخاصة، وفعْله غير المباشر، تعدُّدَ الاختيارات والمواقع والوظائف داخل المجتمع. فالأدب طبقي، نسبيٌّ، تاريخيّ. وكل اختيار جوابٌ لموقع فئة من الفئات الاجتماعية من الصراع الاجتماعي، وهو، في الوقت نفسه، حزامٌ يحْكُم الصلة بين أفراد فئة من الفئات، ويوحّدهُمْ تجاه الاختيارات المتعارضة.
لا يطمحُ هذا البيان إلى تصنيف الأشكال والرؤى، أوالبحث في أصولها وأهدافها الاجتماعية، عبر التاريخ العربي، بقدر ما يريد التوكيد على العلاقة بين الإنتاج الثقافي العربي والواقع الاجتماعي من ناحية، وعلى نسبية هذا الإنتاج ضمن نسبية المجتمع والقيم. هذه بديهيات، نعم، ولكن ما أكثر الذين أصبحوا ينكرونها، ويتصرفون لوهْم الشكلانية!
الكتابة فعلٌ تحرري، وهي أبعدُ ما تَرى إلى النص كذرّة مغلقة، يوجَدُ من باطن أدلة لم ينحتْها تاريخُ اللغة والذات والمجتمع. من ثم فإن الكتابة نزوعٌ إلى عالم مغاير في النص وبالنص. هذا ليس كافياً أيضاً.
لا يزال الشعر المعاصر يفهم المجتمع في ضوء وثنية مانوية : الظلام والنور، الخير والشر، الأعلى والأسفل، القوي والضعيف. تحْكمه رؤية مطلقة متعالية، باعد بينهما في تصوراته وممارسته، مما حصر وعيَه في الجزئي والهامشي، وأرغمه على تكريس قيم يعتقد أنه يقاومها.
ليس القريبُ منفصلاً عن البعيد، ولا الليلُ عن النهار، ولا الكائنُ عن الممكن. إن المجتمع موجود في وحدة تناقضاته وتصارعها، إِقْدَامٌ يلازمُ التراجع. والمجتمع هو هذه الفئاتُ الموحدة المتعارضة التي لا يستسلم أحدُها لغيرها دونما تدخل العنف.
ويظل الشعر المغربي المعاصر إدانة غير مهادنة لسلطة الإرهاب والحِجْر والإرغام، تمارسها الأقلية ضد الأغلبية. على أنه خجولٌ في تشبثه بالحياة، حين سقط في شراك المتعالي والمطلق وهو يقرأ المجتمع في جموده لا في صيرورته، من خلال رؤية وثنية مانوية، ميتافيزيقية. غالبٌ دوماً ومغلوبٌ دوماً، الأول في الأعلى والآخر في الأسفل. الغالبُ يمارس قهْرَ المغلوب. هذا هو قانون الآني والتاريخي لدى هذا الشعر. الأول يختار للناس حجْمَهُم، وغناءَهمَ، وحُلْمَهُم؛ والثاني يتقبل بذلّ ومسكنة هذا الاختيار، يستسلمُ للعسف الذي يقوده إلى الصمت والقبول الدائمين، راضياً بما قدِّرَ له. وحين يحنّ إلى شيء من إنسانيته يستصرخُ كلاماً، يصْعد في سُلَّمٍ خفيٍّ إلى الأعلى، وينتظر الجوابَ حتى ينزل في الميقات الذي لا علْم لأحد به، أو يستسلمُ لإنصافٍ يجيء بعد الموت.
هذه الرؤية هي أول ما يجب تدميرُه بالنص وفي النص، لأن الكتابة عشقٌ شهوانيٌّ مفتوحٌ للحياة. تمنح للغة إمكانية التجدد، وللذات حقّ مُتعتها الفيزيولوجية، وللمجتمع فسحةُ ابتكار علائقه وقيَمه التحررية.
هذه الرؤية الوثنية المانوية الغنوصية تَعْدِلُ بين الثنائيات الميتافيزيقية. وليس غريباً أن يتبناها كلٌّ من العاجز والمستبد. فهُما معاً يدُوران في مجال معرفي واحد موحّد، ولا يتم التمايز وتنكشف المفارقة إلا بالخروج على دائرة الانغلاق المتعالي. يعوّضُ العاجزُ عن الفعل الخلاق عشْقَ الحياة بطَلَبِ الشفقة، ويتمادى المستبدّ في طاغوته بترديد جملة من الأقاويل الرادعة. أما الكتابة فلا مطلقَ ولا متعاليَ ولا شفقةَ ولا ردعَ فيها.
الرؤية المانوية تعلّم القناعة والرضا والقبول، وهي قيم الاستسلام والمَذلّة. نقدُها متّصلٌ بمساءلة المجتمع ونقد قيَم ثوابته الأخلاقية والسياسية والفكرية. مجتمعنا العربي، ومنه المغربي، طبقاتٌ متكلسة من القيم المتعالية، تنْفي الفعلَ والمبادرةَ والخروجَ والتحرر. فمطلقية الوحْدة القديمة غيرُ منفصلة عن مطلقيتها الحديثة. وأجْلَى مظاهر الوحدة في المجتمع العربي هي الإِرهابُ والقمع. هذه هي الوحدة السائدة التي يرفعون لها اليافطات، ويلغَّمُون بها الثقافة. وحدةٌ مضادة لما يحسّه الشعب وهو ينصت لموَّال ينبعث من بعيد.
إن المجتمع العربي، كتراتُب مُبرَّر بأصولية الثبات، وكوحدة مُطوّقة بمُطلقية القيم المتعالية، نقيضُ المجتمع الممكن والمحتمل. ليس التراتبُ إلا عنفَ أقلية مستبدة، وليست القيمُ إلا نسبية، تاريخية. بهذا الوعي النقيض، الوعي النقديِّ، تتقدّم الكتابة. وعيٌ يفيدُ أنْ لا ثبات في المجتمع ولا استسلام، بل هو في حركة مُسترسلة، قد تحفُّ وقد تتوتّر، ويفيد أن القيمَ من اختلاق الإنسان. كل شيء في المجتمع وخارج المجتمع خاضع للتحوّل. لا تعْمَى الكتابة عن رؤية المجتمع في تبدّلاته اللانهائية، ولا تكفّ عن ملاحقة إنسانية الإنسان. فهي، سارقةُ النار، تدمّر استبداد الحاضر، تؤسسُ تحرُّر المستقبل. فكيف لا تلتحمُ الكتابة بالكتلة التاريخية ذات المصلحة في التغيير؟
هذا الوعي النقدي لا يمكن أن يكون شاملاً إلا إذا اخترقت به الكتابةُ متعالياتِ الغرب أيضاً، وقد تسربت إلى رؤيتنا وممارستنا، باسم التفوّق الغربي وتخلّفِ الشعوب غير الغربية. باسْمهمَا حلّت بيننا متعالياتُ الغرب، وفي مقدمتها تأليهُ التقنية الغربية من ناحية، ومحو آثار جسدنا من ناحية ثانية. نقْدُنا لمتعاليات الشرق يتّسقُ ونقدُنا لمتعاليات الغرب. بهذا المعنى تكون الكتابةُ بمعْزل عن التقسيم الأخلاقي ـ الحضاري للشرق والغرب. آثار جسدنا الفردي والجماعي يجبُ أن تستردّ أحقّيتها في اللغة، الذات، المجتمع. وليست استفادتنا من المعرفة الغربية النقدية بدعة.
من هنا نتبيّن أن الإنصاتَ لصوْت الشعب وتفسيرَه لا يعنيان سرقة الكلمة من فَم الشعب. لا تنوبُ الكتابة عن الشعب في التّحْرير، ولكنها مَعهُ في استقدام حياة مغايرة، يختارها بإرادته، يعطي لعشقه فيها شرعية التحقق. لم يصبح الشعبُ العربي أُحادي البُعْد، ولا اختُزِلَتْ أغانيه وأحلامُه في خطاطات الإعلام. تدميرُ الكتابة لاستبدادية الانغلاق وأصولية التراتب والثبات المتعاليتيْن، مندمجٌ في تفسير دواخل هذا الصوت المبعَد المنسيّ، وهو فعْلٌ غيرُ بريء. معهُ تتأصل الشهادةُ في لحظة لها انخطافُ الحال، تألَّقُ الحضرة. ومعها أيضاً ينشبك تجددُ اللغة بمُتعة الذات وبتحرر المجتمع. وها هي الكتابة أفُقٌ أزرقُ، ينْتشي بالنّشيد والاحتفال.
الحد الثالث
- تؤسس الكتابة وتُواجهُ، داخل النص وخارجه، في هذه اللحظة الشعرية التي تتميز بعوْدة السلفية الشعرية، متلبّسة بشعارات اليسار فضلاً عن اليمين. إن الكتابة نقيضُ الوعي الشعري السائد، زمنٌ يفكك الأزمنة الموروثة، لا من خلال خطية النص، كما يتخيّلون ويَخالون، ولكن باعتبار الكتابة رؤيةً وحساسيةً مغايرتيْن، لها الوعي النقدي كأساس لإعادة بنية اللغة والذات والمجتمع. لا تأسيسَ بدون مُواجهة، ولا مُواجهة في بُعْد عن التأسيس. وجْهان للفعل المبدع، مُتناميان، مُتلاحمان، كل منهما يُفْتتح للآخر مقدمته.
قوانين وحدودٌ عامة حاول هذا البيان تلخيصها، بالقدر الذي يسْمَحُ بتعميق تأملنا الراهن في إمكانات الكتابة والعلائق المحتملة بينها وبين الفرد والمجموع، بينها وبين القيم والأصول، بينها وبين الماضي والحاضر والمستقبل، بينها وبين السائد كوعي شعري. و يسعى هذا البيان، في الوقت نفسه، إلى أن يمنح القارئ بعض شرائط الدخول في لعبة قراءة – إعادة كتابة النص، حتى يكشفَ عن فاعليته أثناء مغامرة التفكيك – التركيب، يبحث عن المعنى المتعدّد بدل المعنى الواحد، يسافرَ، ويأخذَ دوْره في التحرّر الجماعي.
- هذا البيان مُرَكّزٌ. وهو، دونما شك، في حاجة إلى المزيد من الشرح والتحليل، على أنه يتضمن وضوحه وتكامله. والأساسُ فيه هو أنه لا يفرضُ منظور الكتابة على أحد. فالشعر أوسع من حجَاج بيَان. لذا، فإن هذه الرؤية للكتابة ليست دعوة قمعية لغيرها من التصورات المُحوَّلة والمغيرة لمنظومة السقوط والانتظار، بل هي، على العكس من ذلك، إلْحاحٌ على تعدُّد أنماط الخروج، إلْحاحٌ على أن يسلك الشعراء الشبانُ مسالك الجرأة على طرح ما يرونه أكثر وعياً باللغة والذات والمجتمع.
إذاً، نحو الحوار يسير هذا البيان، بعد أن فرض علينا الإرثُ التاريخيُّ مواضعات الصمت والانزواء. فلا يمكن لحُلمنا بتحرر الإنسان أن يتحقق بالرأي المفرد الأوحد.
- أخيراً، لابد من الإشارة إلى أن هذا البيان لا يُسَلَّمُ تعاليم تُمَكَّن من ممارسة الكتابة. قوانين وحدود عامة تظل، مهما فُصَّلَ فيها الحديث، عاجزةً عن أنْ تتحوّل إلَى أبجدية.
أيضاً، لا يهدفُ هذا البيان إلى استنطاقَ سؤال فردي، ولا يُسقطُ على الآخرين رؤيتَه. كلُّ واحد له الحق في اعتباره منطلقاً وصياغته لا ترفض أيَّ مراجعة واعية.